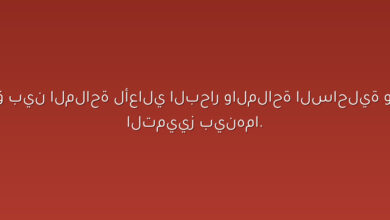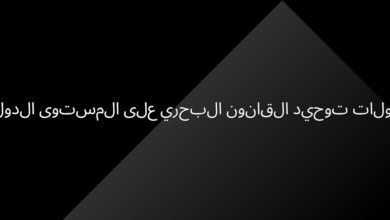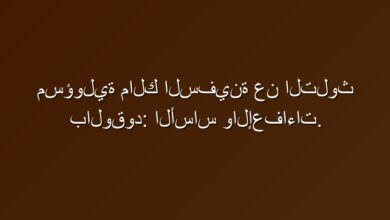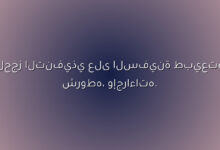تقسيم العقود: استعراض مفصل لأنواع العقود حسب القانون المدني
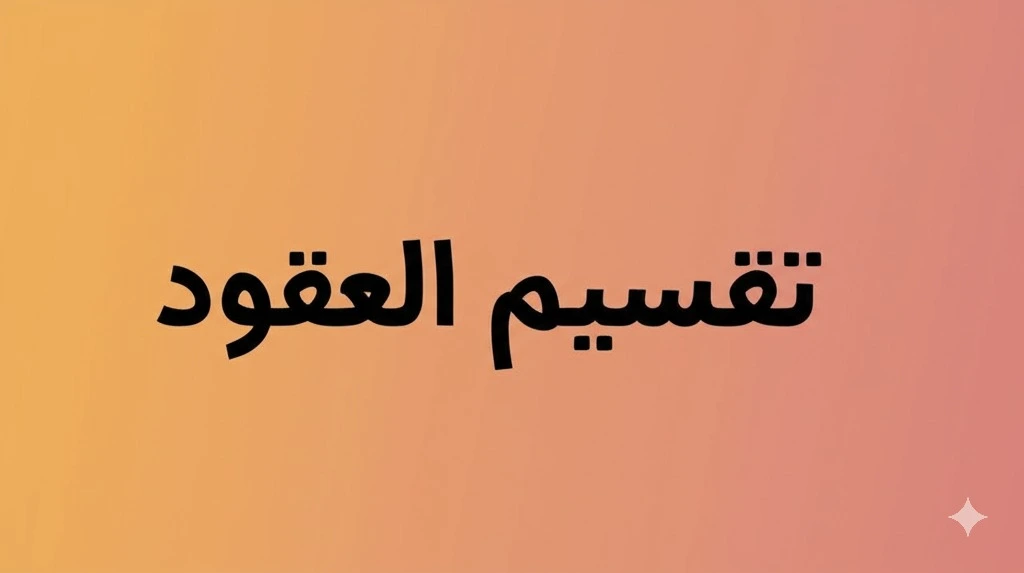
يعد تقسيم العقود من المباحث الأساسية في دراسة القانون المدني وتحديدا ضمن نظرية الالتزام. تختلف العقود وتتنوع بناء على أسس ومعايير متعددة وهو ما يسهل فهم طبيعة كل عقد وآثاره القانونية. يستعرض هذا القسم أهم التقسيمات التي أوردها الفقهاء مع التركيز على ما جاء به الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه “الوسيط” متبعين الترتيب والتفصيل الوارد في الصفحات من 126 إلى 141.
1. تقسيم العقود وفقا لطبيعتها (تمهيد التقسيمات)
قبل الخوض في تفاصيل تقسيم العقود المختلفة لا بد من الإشارة إلى أن التقسيمات غالبا ما تكون متشابكة والعقد الواحد يمكن أن يندرج تحت أكثر من تقسيم واحد في آن معا. ومع ذلك يهدف التقسيم إلى تسهيل الدراسة وفهم الخصائص الجوهرية لكل فئة من العقود. يسعى المشرع عادة وكذلك الفقه والقضاء إلى وضع قواعد تنظيمية تنطبق على مجموعات معينة من العقود تشترك في خصائص محددة. ويشير السنهوري إلى أن التقسيمات الواردة أدناه هي الأهم والأكثر شيوعا في الفقه والقانون.
2. تقسيم العقود من حيث التكوين
يركز هذا النوع من تقسيم العقود على كيفية نشوء العقد وانعقاده صحيحا من الناحية القانونية ويميز بين ثلاثة أنواع رئيسية:
2.1. العقد الرضائي (contrat consensuel)
العقد الرضائي هو العقد الذي يكتفي لانعقاده بمجرد تراضي المتعاقدين أي تطابق الإيجاب والقبول دون الحاجة إلى شكلية معينة يفرضها القانون. بناء على ذلك يعد هذا النوع هو الأصل العام في العقود حيث الرضائية هي القاعدة والاستثناء هو الشكلية أو العينية. ومثال ذلك عقود البيع والإيجار في كثير من الحالات ما لم يتطلب القانون شكلا خاصا.
2.2. العقد الشكلي (contrat solennel)
أما العقد الشكلي فهو الذي لا يكتفي فيه بتراضي المتعاقدين لانعقاده بل يجب أن يتم هذا التراضي في شكل معين يحدده القانون. بعبارة أخرى الشكلية هنا ركن من أركان العقد وليس مجرد شرط لإثباته. فإذا تخلف الشكل المطلوب كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. من أمثلة العقود الشكلية عقد الهبة وعقد الشركة في بعض القوانين وعقد الرهن الرسمي الذي يتطلب التسجيل غالبا.
وهنا يجب التمييز بين الشكلية المطلوبة للانعقاد ( كركن) والشكلية المطلوبة للإثبات. فالأولى تؤثر في صحة وجود العقد نفسه بينما الثانية تتعلق فقط بكيفية إثبات وجوده أمام القضاء إذا أنكر ولا تؤثر على صحة انعقاده إذا استوفى أركانه الأخرى. غير أن السنهوري يوضح أن التطور التشريعي يتجه نحو تقليل формалізм العقود الشكلية حيثما أمكن خاصة في المعاملات التجارية التي تتطلب السرعة. إلا أنه يقر بأن للشكلية فوائدها لا سيما في تنبيه المتعاقدين إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه وتسهيل الإثبات.
تعددت صور الشكلية فقد تكون في ورقة رسمية (acte authentique) يحررها موظف عام مختص (كالكاتب العدل أو الموثق) وقد تكون في ورقة عرفية (acte sous seing privé) موقعة من المتعاقدين. وقد يفرض القانون شكليات إضافية كالتسجيل في سجل معين (كما في الرهن الرسمي أو بيع العقارات في بعض النظم) أو يتطلب إجراءات خاصة أخرى.
يجدر الذكر أيضا أن مفهوم الشكلية في القانون الروماني كان واسعا جدا ثم تطور الفقه نحو التخفيف منها لصالح الرضائية وهو ما تبناه القانون الفرنسي الحديث بدرجة كبيرة ومن ثم القانون المدني المصري متأثرا به حيث الأصل هو الرضائية.
2.3. العقد العيني (contrat réel)
النوع الثالث في تقسيم العقود من حيث التكوين هو العقد العيني. هذا العقد لا يتم بمجرد التراضي ولا بمجرد الشكل بل يتطلب لانعقاده بالإضافة إلى التراضي تسليم العين محل العقد. أي أن التسليم هنا يعتبر ركنا في العقد وليس مجرد التزام ناشئ عنه. إذا لم يتم التسليم لا ينعقد العقد أصلا.
تشمل العقود العينية التقليدية عقودا مثل الوديعة والعارية (عارية الاستعمال) والقرض بنوعيه (قرض الاستهلاك وقرض الاستعمال في بعض التصنيفات) وربما الرهن الحيازي. يشير السنهوري إلى أن الأساس التاريخي لهذا النوع من العقود يعود للقانون الروماني حيث كان ينظر إلى هذه العقود على أنها تتضمن التزاما برد شيء تم تسلمه فكان التسليم منطقيا كبداية للعقد.
ومع ذلك هناك جدل فقهي حديث حول مدى ضرورة الإبقاء على هذه الفئة كفئة مستقلة. يرى البعض أن التراضي وحده كاف لإنشاء التزام بالتسليم وأن التسليم الفعلي يجب اعتباره تنفيذا لالتزام ناشئ عن عقد رضائي تم لا ركنا في انعقاده. وقد أخذت بعض التشريعات الحديثة بهذا الاتجاه وحولت بعض هذه العقود إلى عقود رضائية. القانون المدني المصري تأثرا بالفرنسي أبقى على الصفة العينية لبعض هذه العقود (مثل الهبة التي تتطلب أحيانا القبض والوديعة والعارية في بعض تفسيراتها) ولكنه يميل إلى اعتبار الرضائية هي الأصل. كما يلاحظ أن الوعد بهذه العقود العينية (الوعد بالتسليم) يعتبر صحيحا وملزما مما يثير التساؤل حول منطق اشتراط التسليم للانعقاد الأصلي.
2.4. العقود المختلطة (contrat mixte) أو غير المسماة ضمنا
يشير السنهوري أيضا إلى وجود عقود لا تندرج تماما تحت أي من الأنواع الثلاثة السابقة بشكل حصري ولكنها قد تجمع بين عناصر منها أو عقود لا يمكن وصفها بسهولة تحت تصنيف واحد. كمثال عقد (innommé) غير المسمى أو المختلط الذي يجمع خصائص من أكثر من نوع.
3. تقسيم العقود من حيث الأثر (أو من حيث التزامات طرفيه)
هذا التقسيم ينظر إلى الالتزامات التي ينشئها العقد في ذمة أطرافه بعد انعقاده صحيحا ويميز بشكل أساسي بين نوعين:
3.1. العقد الملزم للجانبين (contrat synallagmatique ou bilatéral)
العقد الملزم للجانبين هو الذي ينشئ منذ لحظة إبرامه التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا للآخر في الوقت نفسه. العلاقة بين الالتزامات المتقابلة هنا هي علاقة ارتباط أو تبادل كل التزام يعتبر سببا (cause) للالتزام المقابل له. ومن أبرز الأمثلة: عقد البيع (البائع يلتزم بتسليم المبيع والمشتري يلتزم بدفع الثمن) وعقد الإيجار (المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين والمستأجر يلتزم بدفع الأجرة). هذا النوع من العقود له أهمية عملية كبرى نظرا لخصائصه وآثاره المتميزة.
3.1.1. آثار العقود الملزمة للجانبين:
تترتب على صفة “التبادلية” هذه آثار هامة لا توجد عادة في العقود الملزمة لجانب واحد:
- الدفع بعدم التنفيذ (exception d’inexécution): إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل حتى يقوم الطرف الأول بتنفيذ ما عليه بشرط أن تكون الالتزامات مستحقة الأداء معا. هذا الحق يجد أساسه في فكرة الارتباط والتقابل بين الالتزامات.
- الفسخ (résolution): إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه في العقد الملزم للجانبين جاز للطرف الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القضاء فسخ العقد ليتحلل بدوره من التزامه. وقد يكون الفسخ قضائيا أو اتفاقيا (بشرط صريح فاسخ) أو قانونيا في حالات معينة. فكرة الفسخ تعتمد أيضا على الارتباط بين الالتزامات؛ فإذا سقط أحد الالتزامات بسبب إخلال أحد الطرفين جاز للطرف الآخر التحلل من التزامه المقابل.
- تحمل التبعة (théorie des risques): في حالة هلاك الشيء محل الالتزام بسبب قوة قاهرة بعد انعقاد العقد وقبل تنفيذه تطرح مشكلة مَن يتحمل تبعة هذا الهلاك. القاعدة في العقود الملزمة للجانبين هي أن تبعة الهلاك يتحملها المدين بالالتزام الذي أصبح مستحيلا (فينقضي التزامه) وينقضي معه الالتزام المقابل للدائن بهذا الالتزام فيتحمل الدائن تبعا لذلك (قاعدة res perit debitori في هذا السياق تعني الدائن بالالتزام المستحيل). هناك استثناءات خاصة في العقود الناقلة للملكية حيث قد يتحمل المشتري التبعة بمجرد انتقال الملكية إليه ولو قبل التسلم في بعض الأحيان (res perit domino) ولكن القاعدة العامة المذكورة أعلاه هي الأساس في الالتزامات غير المرتبطة بنقل ملكية فورية.
كل هذه الآثار (الدفع بعدم التنفيذ الفسخ تحمل التبعة بقاعدة انفساخ الالتزام المقابل) تجد أساسها المشترك في فكرة “السبب” أو “الارتباط المتبادل” (interdépendance) بين الالتزامات في هذا النوع من تقسيم العقود.
3.2. العقد الملزم لجانب واحد (contrat unilatéral)
العقد الملزم لجانب واحد هو العقد الذي ينشئ منذ لحظة إبرامه التزامات في ذمة أحد طرفيه فقط دون الطرف الآخر فيكون أحدهما مدينا والآخر دائنا غير مدين. أمثلة هذا النوع تشمل عقد الوديعة غير المأجورة (الملتزم هو المودع لديه فقط برد الوديعة) وعقد العارية (الملتزم هو المستعير فقط برد الشيء المعار) وعقد القرض (الملتزم هو المقترض فقط برد مثل ما اقترضه) والهبة بدون عوض (الملتزم هو الواهب فقط بتسليم الشيء الموهوب إذا لم يتم التسليم فورا وإلا فالعقد قد يكون تم وانتهى).
من المهم التمييز بين العقد الملزم لجانب واحد والتصرف القانوني الصادر من جانب واحد (acte juridique unilatéral). فالعقد يتطلب دائما توافق إرادتين (إيجاب وقبول) حتى ولو أنشأ التزامات على عاتق طرف واحد فقط. أما التصرف من جانب واحد فينشأ بإرادة منفردة كالإيصاء أو الوعد بجائزة.
الآثار التي تميز العقد الملزم للجانبين (الدفع بعدم التنفيذ الفسخ تحمل التبعة بقاعدة انقضاء الالتزام المقابل) لا تنطبق كقاعدة عامة على العقد الملزم لجانب واحد لأنه لا توجد التزامات متقابلة أصلا يمكن تطبيق هذه القواعد عليها. فالفسخ لا محل له وتحمل التبعة يكون على المدين بالالتزام الوحيد الموجود والدفع بعدم التنفيذ غير وارد.
3.3. العقد الملزم للجانبين الناقص أو غير الكامل (contrat synallagmatique imparfait)
يشير السنهوري إلى فئة خاصة يسميها بعض الفقهاء “العقد الملزم للجانبين الناقص”. هذا العقد ينشأ في الأصل ملزما لجانب واحد ولكن قد يطرأ أثناء تنفيذه ظرف يجعله ينشئ التزاما عرضيا في ذمة الطرف الآخر (الذي كان دائنا فقط في الأصل). مثال ذلك الوديعة غير المأجورة: إذا أنفق المودع لديه مصروفات ضرورية لحفظ الوديعة نشأ التزام على المودع (الدائن الأصلي) برد هذه المصروفات للمودع لديه. بالرغم من ظهور هذا الالتزام الجديد لا يصبح العقد ملزما للجانبين بالمعنى الأصلي لأن الالتزام الجديد لم ينشأ تبادليا مع الالتزام الأصلي بل نشأ بسبب عارض لاحق. لذلك لا تطبق عليه في الغالب قواعد العقود الملزمة للجانبين كالدفع بعدم التنفيذ أو الفسخ بالمعنى الدقيق. لكن الفقه يقر للمدين بالالتزام اللاحق (المودع لديه في المثال) بحق حبس الشيء (droit de rétention) حتى يستوفي حقه وهو ما يشبه جزئيا الدفع بعدم التنفيذ. نشأت فكرة هذا العقد في القانون الروماني وتأثر بها القانون الفرنسي القديم.
راجع أيضا : تعريف العقد في القانون المدني: تمييزه عن الاتفاق وشروطه الأساسية
4. تقسيم العقود من حيث طبيعة المقابل
يركز هذا التصنيف على ما إذا كان كل متعاقد يحصل على مقابل لما يعطيه أم لا.
4.1. عقود المعاوضة (contrats à titre onéreux)
عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه للآخر. هذا هو الغالب في المعاملات المالية. لا يشترط في المقابل أن يكون متعادلا تماما في القيمة مع ما أعطاه الطرف الآخر (فكرة الغبن لها أحكامها الخاصة) ولكن المهم هو وجود نية الحصول على مقابل لدى كل طرف. عقود البيع والإيجار والمقايضة والشركة هي أمثلة نموذجية لعقود المعاوضة.
4.1.1. أنواع عقود المعاوضة:
تنقسم عقود المعاوضة بدورها إلى قسمين:
- العقد المحدد (contrat commutatif): هو عقد المعاوضة الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين وقت إبرام العقد أن يعرف مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي أي أن التزامات كل طرف محددة وواضحة من البداية. البيع بثمن محدد والإيجار بأجرة محددة أمثلة على ذلك.
- العقد الاحتمالي (contrat aléatoire): هو عقد المعاوضة الذي لا يستطيع فيه أي من المتعاقدين وقت إبرام العقد أن يحدد مقدار ما سيأخذ أو ما سيعطي بالضبط لأن هذا المقدار يتوقف على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع أي على عامل الاحتمال أو “الحظ”. من أمثلته: عقد التأمين (المؤمّن له يأخذ قسطا محددا لكن ما يعطيه يتوقف على تحقق الخطر المؤمَّن منه والمؤمَّن له يدفع قسطا محددا ولكن ما قد يأخذه غير مؤكد) وعقد المقامرة والرهان (إن كانا مشروعين) والبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى حياة البائع أو المشتري أو شخص ثالث.
أهمية هذا التمييز داخل عقود المعاوضة تظهر في أن أحكام الغبن (lésion) لا تطبق عادة على العقود الاحتمالية لأن عنصر الاحتمال جزء أصيل من طبيعتها فكل طرف دخل العقد وهو يعلم باحتمال الربح أو الخسارة.
4.2. عقود التبرع (contrats à titre gratuit)
عقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما أعطاه أو لا يعطي فيه المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه. أي أن أحد الطرفين يتبرع للآخر بشيء ما دون نية الحصول على عوض. من أبرز أمثلته الهبة والعارية (عارية الاستعمال) غير المأجورة والوديعة غير المأجورة والقرض بدون فائدة.
لعقود التبرع أحكام خاصة غالبا ما تكون أشد من عقود المعاوضة. فالمسؤولية على المتبرع تكون عادة أخف (لا يضمن العيوب الخفية في الهبة إلا استثناء) وقد تتطلب شكلية خاصة لحمايته من التسرع (كهبة العقار) وتكون الأهلية المشترطة فيه أعلى ولا يجوز الطعن فيها بالدعوى البوليصية من دائني المتبرع بسهولة كما في المعاوضة. النظرة إلى شخصية المتبرع له (intuitus personae) تكون غالبا أساسية في هذه العقود فيبطل العقد إذا كان هناك غلط في شخص المتبرع له وقد تنتهي بوفاته.
4.2.1. التمييز بين عقد التبرع والعقد الملزم لجانب واحد وعقد المعاوضة الاحتمالي:
- عقد التبرع قد يكون ملزما لجانب واحد (كالهبة غير المقترنة بتكليف) أو قد يكون عقدا شكليا أو عينيا لا ينشئ التزامات أصلا (كالهبة التي تنفذ فورا بالقبض). المهم فيه هو نية التبرع.
- ليس كل عقد ملزم لجانب واحد هو عقد تبرع. فالكفالة قد تكون ملزمة للكفيل فقط لكنها قد تكون معاوضة إذا كان الكفيل يأخذ أجرا من المدين الأصلي.
- عقد المعاوضة الاحتمالي يختلف عن التبرع؛ ففي الأول يوجد احتمال كسب وخسارة لكلا الطرفين ونية معاوضة أما في التبرع فأحد الطرفين يقصد إثراء الآخر دون مقابل.
4.3. العقود المختلطة (التي تجمع بين المعاوضة والتبرع)
توجد عقود تجمع بين الصفتين كالهبة مع تكليف (donation avec charge) إذا كان التكليف أقل قيمة من الموهوب أو البيع بثمن بخس جدا قصد به التبرع جزئيا. هذه العقود تأخذ حكما وسطا يراعي الطبيعة الغالبة أو يطبق قواعد كلا النوعين بقدر ما ينطبق.
5. تقسيم العقود من حيث طبيعة تنفيذها الزمني
ينظر هذا النوع من تقسيم العقود إلى الزمن كعنصر في تحديد الالتزامات الناشئة عن العقد وتنفيذها.
5.1. العقد الفوري (contrat instantané أو contrat à exécution instantanée)
العقد الفوري هو الذي لا يعتبر الزمن فيه عنصرا جوهريا بحيث يمكن بل يجب عادة تنفيذه دفعة واحدة فور انعقاده أو بعد أجل قصير لا علاقة له بتحديد مقدار الالتزام. مثال ذلك عقد البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع ودفع الثمن فورا أو حتى لو اتفق على تأجيل التسليم أو الثمن لأجل معين فالأجل هنا لتأخير التنفيذ لا لتحديد مقداره. الزمن هنا لا يتدخل في تحديد حجم الأداء المطلوب.
آثار هذا النوع من حيث الفسخ أو البطلان هي أنه إذا فسخ العقد أو أبطل أمكن إعمال الأثر الرجعي بحيث يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد كأن لم يكن العقد قد أبرم أصلا (مع مراعاة حقوق الغير حسن النية).
5.2. العقد الزمني أو المستمر أو عقد المدة (contrat successif ou contrat à exécution successive)
العقد الزمني هو الذي يعتبر الزمن فيه عنصرا جوهريا وأساسيا بحيث يكون هو المقياس الذي يحدد مقدار محل العقد أو على الأقل يكون عاملا رئيسيا في تحديد نطاق الالتزامات. الالتزامات هنا تتتابع وتتكرر وتنفذ على دفعات دورية أو بصورة مستمرة طوال مدة العقد. ومن الأمثلة الواضحة: عقد الإيجار (الأجرة تحسب بالمدة والانتفاع مستمر طوالها) وعقد العمل (الأجر غالبا يحسب بالمدة والعمل يستمر خلالها) وعقد التوريد (كتوريد كهرباء أو غاز حيث الالتزام مستمر ويقاس بالزمن والاستهلاك) وعقد الإيراد المرتب.
للتمييز أهمية بالغة خاصة من حيث:
- الفسخ والإنهاء (Résiliation): إذا فسخ عقد زمني فإن الفسخ لا يكون له أثر رجعي بل يعمل للمستقبل فقط. فالآثار التي ترتبت في الماضي (كالانتفاع بالعين ودفع الأجرة عن تلك المدة) تبقى صحيحة لأنه يستحيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة للمدة المنقضية. لذا لا يسمى “فسخا” بالمعنى الدقيق بل “إنهاء” (résiliation) للعقد بالنسبة للمستقبل.
- الإعذار: في العقود الفورية الإعذار شرط لاستحقاق التعويض عن التأخير. في العقود الزمنية قد لا يكون ضروريا لاستحقاق الالتزامات المتأخرة (كالأجرة) عن المدد الماضية لأن الزمن يحل بذاته دون حاجة لإثبات حلول الأجل.
- نظرية الظروف الطارئة: هذه النظرية تجد مجالا أوسع للتطبيق في العقود الزمنية لأنها تفترض تغير الظروف بشكل كبير وغير متوقع أثناء تنفيذ العقد الممتد في الزمن مما يجعل التنفيذ مرهقا. أما في العقود الفورية التي تنفذ دفعة واحدة ففرصة تغير الظروف أقل.
- تجديد العقد (Tacite reconduction): العقود الزمنية (خاصة الإيجار) كثيرا ما تقبل التجديد الضمني إذا استمر الطرفان في تنفيذها بعد انتهاء مدتها الأصلية دون اعتراض.
راجع أيضا : مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني: المفهوم، التطور، والقيود
6. تقسيم العقود من حيث تنظيم القانون لها
يميز الفقه أيضا بين العقود بناء على ما إذا كان المشرع قد خصها بتنظيم معين أم لا.
6.1. العقد المسمى (contrat nommé)
العقد المسمى هو العقد الذي خصه المشرع باسم معين ونظم أحكامه بقواعد خاصة في القانون نظرا لشيوعه وأهميته العملية. القانون المدني عادة ينظم تفصيليا عقودا كالبيع والإيجار والوكالة والمقاولة والشركة والتأمين والكفالة والقرض وغيرها. هذه القواعد الخاصة تكمل القواعد العامة لنظرية العقد وقد تخالفها أحيانا لمقتضيات خاصة بهذا العقد.
6.2. العقد غير المسمى (contrat innommé)
العقد غير المسمى هو الذي لم يخصه المشرع باسم معين ولم ينظم أحكامه بقواعد خاصة بل يخضع فقط للقواعد العامة المقررة لجميع العقود في نظرية الالتزام ونظرية العقد. مثل هذه العقود تنشأ من إبداع المتعاقدين لتلبية حاجات عملية مستجدة لا تغطيها العقود المسماة الشائعة. من أمثلته (في بعض الأحيان حيث قد تصبح مسماة بتدخل المشرع لاحقا): عقد النزول بالفندق (الذي يجمع عناصر من الإيجار والوديعة وبيع الأطعمة والعمل) عقد النشر عقد الدعاية والإعلان عقد الترخيص باستغلال اسم تجاري (Franchise) وغيرها الكثير مما تفرزه التعاملات الحديثة.
حرية المتعاقدين (سلطان الإرادة) هي التي تسمح بإنشاء هذه العقود غير المسماة بشرط ألا تخالف النظام العام أو الآداب. والتكييف القانوني لهذه العقود (أي تحديد طبيعتها والقواعد الواجبة التطبيق عليها) قد يكون محل صعوبة قضائية. قد يكيفها القاضي قياسا على أقرب عقد مسمى لها أو قد يمزج بين أحكام عقود مسماة مختلفة تتشابه عناصرها مع العقد غير المسمى أو قد يعاملها كوحدة مستقلة تخضع للقواعد العامة فقط ولما اتفق عليه المتعاقدون.
7. تقسيم العقود من حيث طبيعة مفاوضاتها
على الرغم من أن الأصل هو حرية التفاوض إلا أن الواقع العملي أفرز صورا أخرى لانعقاد العقود:
7.1. عقود المساومة (Contrats de gré à gré)
وهي العقود التي تتم بعد مفاوضات حرة ومتكافئة بين الطرفين يتساومان فيها
حول شروط العقد ويصلان إلى اتفاق يعكس إرادتهما المشتركة بحرية. هذا هو النموذج الأصلي للعقد.
7.2. عقود الإذعان (Contrats d’adhésion)
عقد الإذعان هو الذي يسلّم فيه أحد الطرفين (المذعن) بشروط مقررة
يضعها الطرف الآخر (القوي غالبا) ولا يقبل مناقشتها أو تعديلها.
يكون القبول هنا مجرد إذعان للشروط المفروضة. هذا النوع شائع في عقود الخدمات الأساسية
التي تقدمها شركات تحتكر الخدمة (كالكهرباء والمياه والنقل العام) وفي عقود التأمين النموذجية والعقود البنكية.
المشرع الحديث إدراكا منه لاحتمال تعسف الطرف القوي يتدخل غالبا لحماية الطرف المذعن
فيعطي القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها ويفسر الشك دائما لمصلحة الطرف المذعن.
8. البحث في العقود (مجالات الدراسة)
يختتم السنهوري هذا القسم بالإشارة إلى أن دراسة كل عقد يجب أن تشمل عادة ثلاثة محاور رئيسية:
- أركان العقد: وتشمل التراضي (وجوده وصحته) والمحل والسبب والشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية.
- آثار العقد: وهي الالتزامات التي ينشئها في ذمة كل طرف وحقوق كل منهما.
- انحلال العقد: ويشمل أسباب انقضاء الرابطة العقدية كالبطلان أو الفسخ/الإنهاء أو التقابل (الإقالة) أو اتحاد الذمة أو استحالة التنفيذ.
هذه التقسيمات للعقود تمثل أدوات تحليلية أساسية لفهم النظام القانوني للعقود وتنظيم العلاقات التعاقدية في المجتمع.
المراجع الخاصة بموضوع ” تقسييم العقود “
تم الاعتماد في هذا الموضوع على ما ورد في كتاب “الوسيط في شرح القانون المدني
– الجزء الأول: مصادر الالتزام” للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري تحديدا في الصفحات 126 حتى 141.