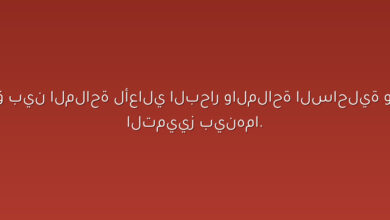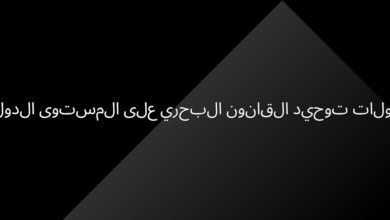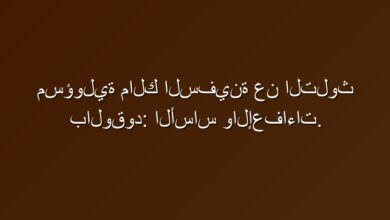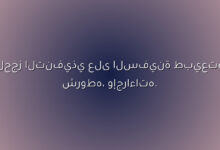مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني: المفهوم التطور والقيود

1. مفهوم مبدأ سلطان الإرادة وأساسه النظري
1.1. تعريف المبدأ وجوهره الأساسي
يعدّ مبدأ سلطان الإرادة أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون المدني وخصوصا في مجال الالتزامات والعقود. يفيد هذا المبدأ بأن الإرادة الفردية هي صاحبة السلطان المطلق في إنشاء الآثار القانونية وأن كل ما يترتب على هذه الآثار من التزامات وحقوق إنما هو وليد هذه الإرادة وحدها. بمقتضى هذا المبدأ تكون الإرادة هي المصدر الجوهري للالتزامات بحيث لا يمكن تصور وجود التزام أو حق دون أن تكون هناك إرادة حرة قد اتجهت إلى إحداثه. هذا يعني أن الفرد لا يلزم إلا بما ارتضاه ولا يلتزم إلا بناء على إرادته الحرة الواعية. فالشخص الذي يلتزم بموجب عقد إنما يلتزم لأنه أراد ذلك ولأن التزامه يعكس تعبيرا عن حريته الشخصية.
1.2. الجذور التاريخية والفلسفية لـ مبدأ سلطان الإرادة
تضرب جذور مبدأ سلطان الإرادة في أعماق التاريخ الفكري والفلسفي. فقد ارتبط هذا المبدأ ارتباطا وثيقا بالنظام الاجتماعي والسياسي القائم على المذهب الفردي. فكما أن النظام الاجتماعي بحسب هذا المذهب يقوم على الأفراد وحرياتهم كذلك ينظر إلى القانون على أنه أداة لخدمة هذه الحريات وتحديدا حرية الإرادة الفردية.
تعزز هذا الفكر بشكل خاص مع ظهور المذاهب الطبيعية وفلسفة العقد الاجتماعي ولا سيما أفكار جان جاك روسو. وفقا لهذه النظريات يتمتع الفرد بحقوق طبيعية أصيلة سابقة على وجود الدولة والمجتمع ومن ضمنها حقه في التعبير عن إرادته بحرية. والقانون في هذا السياق لا يهدف إلا إلى تنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات. وبالتالي اعتبرت الإرادة هي القوة الخالقة للحقوق والالتزامات.
لقد انعكس هذا التوجه الفردي بشكل جلي في التشريعات التي أعقبت الثورة الفرنسية وعلى رأسها القانون المدني الفرنسي (قانون نابليون) والذي كان ينظر إليه كحصن للحريات الفردية. لقد اعتبر القانون حينها أن أفضل وسيلة لتحقيق العدالة والمنفعة العامة هي ترك الأفراد أحرارا في تنظيم علاقاتهم كما يشاؤون طالما أن ذلك لا يتعارض مع أسس النظام الاجتماعي. لكن هذا المفهوم المطلق للإرادة لم يدم طويلا إذ بدأت تظهر قيود وتحديات جديدة.
2. التطور التاريخي لمبدأ سلطان الإرادة والاتجاه نحو تقييده
2.1. عوامل ضعف المبدأ وتأثير المذاهب الاجتماعية
مع مرور الوقت وظهور تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة بدأت النظرة المطلقة إلى مبدأ سلطان الإرادة تتراجع تدريجيا. لقد أظهرت التجربة أن ترك الحرية التعاقدية دون قيود قد يؤدي إلى استغلال الطرف القوي للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مما ينافي اعتبارات العدالة الاجتماعية. كذلك أدت المذاهب الاشتراكية وظهور الأفكار المتعلقة بالوظيفة الاجتماعية للملكية والحقوق إلى إعادة النظر في الدور المطلق للإرادة الفردية. لم تعد الإرادة تعتبر المصدر الأوحد للقانون أو أنها يجب أن تكون دائما فوق اعتبارات المصلحة العامة.
بناء على ذلك بدأ المشرع في العديد من الدول يتدخل لوضع قيود على حرية الإرادة حماية للطرف الضعيف وتحقيقا للتوازن الاجتماعي. ظهرت فكرة “النظام العام الاقتصادي والاجتماعي” كأداة لتقييد الحرية التعاقدية ولم يعد مقبولا القول بأن “ما أراده المتعاقدان هو بالضرورة عادل”. أصبحت الدولة تلعب دورا أكبر في تنظيم العلاقات التعاقدية خاصة في المجالات التي تمس المصالح الأساسية للمجتمع مثل العمل والإسكان والتأمين.
2.2. دور المشرع في وضع قيود على الإرادة الحرة
يتجلى تدخل المشرع لتقييد مبدأ سلطان الإرادة من خلال وضع “قواعد آمرة” لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها. هذه القواعد تهدف إلى حماية النظام العام والآداب أو تحقيق مصلحة عامة يعتبرها المشرع أولى بالرعاية من حرية الأفراد المطلقة في التعاقد. تختلف هذه القواعد الآمرة من تشريع لآخر ومن وقت لآخر ولكنها تشترك جميعا في كونها تمثل حدا قانونيا لسلطان الإرادة.
على سبيل المثال في عقود العمل يضع المشرع حدودا دنيا للأجور وساعات العمل وشروط السلامة المهنية ولا يستطيع العامل وصاحب العمل الاتفاق على ما هو أدنى من هذه الحدود حتى لو رضيا بذلك. وكذلك في عقود الإيجار قد يتدخل المشرع لتحديد الزيادات المسموح بها في الأجرة أو لحماية المستأجر من الإخلاء التعسفي. كل هذه الأمثلة تبين كيف أن سلطان الإرادة لم يعد مطلقا بل أصبح مقيدا بالقانون والنظام العام.
3. أهمية مبدأ سلطان الإرادة وتجلياته في مصادر الالتزام
3.1. هيمنة الإرادة في نطاق العقود (الحرية التعاقدية)
على الرغم من القيود المتزايدة لا يزال لمبدأ سلطان الإرادة أهمية كبرى في القانون المدني وتتجلى هيمنته بشكل واضح في نظرية العقد. فالعقد هو المصدر الأساسي للالتزامات الإرادية ويقوم على فكرة توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. الحرية التعاقدية التي تعدّ تطبيقا مباشرا لمبدأ سلطان الإرادة تتضمن جوانب متعددة:
- حرية الفرد في أن يتعاقد أو لا يتعاقد.
- حرية الفرد في اختيار الطرف الآخر الذي يتعاقد معه.
- حرية الأطراف في تحديد مضمون العقد وشروطه وآثاره بما لا يخالف النظام العام والآداب.
هذه الحرية تجعل من العقد أداة فعالة لتنظيم العلاقات المالية والاجتماعية بين الأفراد وتعكس احترام القانون لإرادة الأشخاص وقدرتهم على تدبير شؤونهم بأنفسهم. بالمقابل فإن دور الإرادة يقل نسبيا في مصادر الالتزام الأخرى غير التعاقدية مثل الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) والإثراء بلا سبب حيث تنشأ الالتزامات بموجب القانون مباشرة بغض النظر عن إرادة الملتزم أو حتى ضدها أحيانا لحماية حقوق الغير أو تحقيق العدالة.
راجع أيضا : تعريف العقد في القانون المدني: تمييزه عن الاتفاق وشروطه الأساسية
3.2. العقد شريعة المتعاقدين والآثار المترتبة على المبدأ
من أبرز النتائج المترتبة على الاعتراف بـمبدأ سلطان الإرادة في نطاق العقود القاعدة الشهيرة المعروفة بـ “العقد شريعة المتعاقدين” (Pacta sunt servanda). تعني هذه القاعدة أن العقد الصحيح الذي نشأ عن إرادة حرة يكتسب قوة ملزمة تعادل قوة القانون بالنسبة لأطرافه. بناء على ذلك يجب على المتعاقدين تنفيذ الالتزامات التي تضمنها العقد بحسن نية ولا يجوز لأي منهما أن ينقض العقد أو يعدله بإرادته المنفردة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو بناء على اتفاق الطرفين.
كما يترتب على هذا المبدأ نتيجة أخرى هامة وهي نسبية أثر العقد. فالعقد كقاعدة عامة لا يلزم إلا أطرافه ولا يكسب حقا أو يفرض التزاما على الغير الذي لم يكن طرفا فيه أو ممثلا له. هذه النسبية تحافظ على حرية الغير وتحترم إرادته فلا يمكن فرض آثار عقد لم يشارك فيه ولم يرتضه. ومع ذلك توجد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.
3.3. الاستثناءات والتحديات الحديثة (عقود الإذعان)
لم يسلم مبدأ سلطان الإرادة من التحديات في العصر الحديث حتى في معقله الرئيسي وهو العقد. من أبرز هذه التحديات ظهور “عقود الإذعان” (Contrats d’adhésion). في هذه العقود يقوم أحد الطرفين (غالبا ما يكون الطرف الأقوى اقتصاديا كشركات المرافق العامة أو التأمين) بصياغة شروط العقد مسبقا ولا يكون أمام الطرف الآخر إلا قبول هذه الشروط جملة أو رفض التعاقد كلية. هنا تبدو إرادة الطرف المذعن محدودة للغاية ولا يعبر العقد عن توافق حقيقي بين إرادتين متساويتين بقدر ما يعبر عن إذعان إرادة لإرادة أخرى.
يثير هذا النوع من العقود تساؤلات حول مدى تطبيق مبدأ سلطان الإرادة بشكله التقليدي. لذلك تدخل المشرع والقضاء غالبا لتفسير الشك في هذه العقود لمصلحة الطرف المذعن أو لإبطال الشروط التعسفية التي قد تتضمنها حماية للطرف الضعيف وتحقيقا للتوازن العقدي. كذلك فإن انتشار العقود النموذجية والعقود الجماعية (مثل عقود العمل الجماعية) يمثل أيضا تطورا يبتعد عن الفكرة الأصلية للعقد كصنيعة فردية خالصة للإرادة.
4. القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة: النظام العام والآداب
4.1. مفهوم النظام العام ودوره كقيد على حرية الإرادة
أوضحنا سابقا أن حرية الإرادة ليست مطلقة بل مقيدة بعدم مخالفة القانون والنظام العام والآداب. يعتبر “النظام العام” (Ordre public) القيد الرئيسي والأكثر أهمية على سلطان الإرادة. يقصد بالنظام العام مجموعة المصالح والقيم الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتي يرى المشرع ضرورة حمايتها حتى لو تعارض ذلك مع الإرادة الحرة للأفراد.
تعتبر قواعد القانون المتعلقة بتنظيم الأسرة وأهلية الأشخاص وحرمة جسم الإنسان وتجريم أفعال معينة من القواعد المتعلقة بالنظام العام. فلا يجوز مثلا الاتفاق على الزواج المؤقت إذا كان القانون يمنعه أو الاتفاق على ارتكاب جريمة أو التنازل عن الأهلية. كل اتفاق يخالف هذه القواعد الأساسية يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لأنه يمس مصلحة عليا للمجتمع تتجاوز مصالح الأطراف المتعاقدة.
4.2. طبيعة النظام العام المتغيرة ودور القضاء
من المهم الإشارة إلى أن مفهوم النظام العام ليس جامدا أو ثابتا بل هو مفهوم مرن ومتطور يتغير بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقيم السائدة في المجتمع. فما قد يعتبر مخالفا للنظام العام في زمن معين أو في مجتمع معين قد لا يكون كذلك في زمن أو مجتمع آخر. هذا التطور يجعل من الصعب وضع قائمة حصرية بالقواعد المتعلقة بالنظام العام.
نتيجة لهذه الطبيعة المرنة يلعب القضاء دورا حيويا في تحديد ما إذا كان اتفاق معين يخالف النظام العام أم لا في ضوء الظروف المحيطة به والقيم السائدة. يمارس القاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال مسترشدا بروح التشريع ومبادئه العامة والمصالح الأساسية للمجتمع. ومع ذلك يجب على القاضي استخدام هذه السلطة بحذر حتى لا يتحول تقييد حرية التعاقد إلى قاعدة وتصبح الحرية هي الاستثناء. ظهر مفهوم “التوجيه التعاقدي” (Dirigisme contractuel) ليعبر عن التدخل المتزايد للمشرع والقضاء في تنظيم محتوى العقود لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية.
4.3. الآداب العامة كقيد إضافي
إلى جانب النظام العام تمثل “الآداب العامة” أو “الأخلاق الحميدة” (Bonnes mœurs) قيدا آخر على سلطان الإرادة. يقصد بالآداب مجموعة القواعد الأخلاقية الأساسية التي يستقر عليها ضمير الجماعة في وقت معين. وتشمل هذه الآداب ما يتعلق بالعلاقات الجنسية والنزاهة في المعاملات واحترام الكرامة الإنسانية.
فالاتفاق على إنشاء بيت للدعارة أو على مقامرة غير مشروعة أو أي اتفاق آخر يتضمن عملا منافيا للحياء أو الشرف يعتبر باطلا لمخالفته للآداب العامة. وكما هو الحال بالنسبة للنظام العام فإن مفهوم الآداب أيضا يتسم بالمرونة والتطور ويخضع لتقدير القاضي في ضوء قيم المجتمع السائدة.
5. مبدأ سلطان الإرادة في القانون الحديث: التوازن بين الحرية والمسؤولية
ختاما يمكن القول بأن مبدأ سلطان الإرادة قد شهد تحولا كبيرا عبر التاريخ. فبعد أن كان ينظر إليه كسلطان مطلق للإرادة الفردية في عصر المذهب الفردي أصبح في القانون الحديث مبدأ نسبيا مقيدا باعتبارات النظام العام والآداب ومتطلبات العدالة الاجتماعية. لم يعد العقد مجرد تعبير عن إرادتين بل أصبح أداة لتحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية تخضع لرقابة القانون والمجتمع.
ومع ذلك لا يعني هذا التطور اختفاء المبدأ أو فقدانه لأهميته. فلا تزال حرية الإرادة هي الأساس الذي يقوم عليه العقد ولا يزال احترام التعهدات الإرادية قيمة أساسية في النظام القانوني. إنما التغير الجوهري يكمن في تحقيق توازن جديد بين حرية الفرد ومسؤوليته تجاه المجتمع وبين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. أصبح سلطان الإرادة محكوما بضوابط تضمن عدم استخدامه للإضرار بالغير أو لمخالفة القيم الأساسية للمجتمع مما يجعله أداة لتحقيق التقدم والعدل وليس أداة للفوضى أو الاستغلال. لا يزال القانون يعترف بقوة الإرادة الملزمة (العقد شريعة المتعاقدين) ويحمي حرية الأفراد في تنظيم علاقاتهم ولكن ضمن الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة وحماية الطرف الضعيف.
المراجع والهوامش
- (١) أنظر على الأخص المذاهب المختلفة في مصادر الالتزام و التطور التشريعي ص ١٢٣ فقرة ٤٠ و ما بعدها.
و في نقد هذه النظرية من وجهة اجتماعية و اقتصادية بحث مسهب لبيجو Peyreau ص ١٣ – ٦٣.
وانظر كذلك ديموج Demogue ص ٢١ – ص ٥١. و الدكتور السنهورى – مصادر الحق في الفقه الإسلامى ج ۲ ص ٢٤١ و ما بعدها فقرة ۱۷۸ .
و انظر فى مصادر الالتزام ج ۱ ص ۱۱۷. - (۲) فى تطور نظرية الإرادة وتناقض هذا التطور مع مبادىء المذهب الفردى الذي قامت عليه في الأصل نظرية الإرادة وفى مصيرها الأخير
فى مستقبل الجماعات المتحضرة انظر في التشريع الفرنسي جو سران josserand في محاضرات ألقاها في الكلية الفنية بمنتريال
ونشرها تحت عنوان L’essor moderne du concept contractuel وخاصة ص ٢٥ وما بعدها ص ٣٧ و ما بعدها وص ٦٢ وما بعدها.
وانظر رسائل كثيرة خاصة بأثر التطور الاقتصادي على العقد مثل :
رسالة لياسون Liassion) ۱۹۲۷ ورسالة جيوم ( Guillauma ) ۱۹۲۸ وغيرهما وهى كثيرة تبلغ العد. ورسالة بيرجمان Bergman سنة ۱۹۲۸
عن تفسير الإرادة ( نظر المؤلف هامش ٥٤٧ – ص ٩٦٣ ) وكلها رسائل في القانون المدنى مسجلة بكلية الحقوق بجامعة باريس .
و راجع ريبر Rappert أستاذ بكلية حقوق باريس فى الخطأ في إبراز هذا التقادم ص ٣٥ – ١٣٠. - (۳) أنظر في هذه النظرية وفى بيان آثارها وتناقضها الآن بل وتصفيتها الأستاذ سرفاتييه Professeur René Savatier
الأستاذ بكلية حقوق بواتيه في دراسة أعمق ضمنها مجلة التشريع والاجتهاد Dallos Chronique سنة ١٩٥٠ من ص ۹۳ الی ۱۰۰.